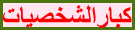بحث حول الديمقراطية
في طرح مسألة الديمقراطية في إطار جدلية الداخل والخارج تضيع أحيانا الفروق الجوهرية بين عملية بناء وتأسيس الديمقراطية وعملية إعادة انتاجها لذاتها بعد أن تأسست واصبحت قادرة على ذلك. وما يساهم في طمس
الفروق أن الديمقراطية تصلنا جاهزة بعد تطور مئات السنين، مما يشجع البعض على التوهم بأنه ليس بحاجة الى تأسيسها ولا حتى الى تأسيس العناصر المكونة والآليات الاقتصادية اللازمة لاعادة انتاجها يوميا.
وكأن الانتقال الى الموقف الديمقراطي هو انتقال من خيار استهلاكي الى خيار استهلاكي آخر، الى بضاعة أخرى رائجة، لا تأسيس ولا اعادة انتاج. ومن ناحية أخرى فإن ورود الديمقراطية الى المنطقة العربية جاهزة يعني أنه لا يمكن تخيل العودة من جديد على بداياتها بحق اقتراع غير معمم الا لفئة صغيرة مثلا ثم تعميمها تدريجيا، كما حصل في بريطانيا وفي فرنسا وغيرهما عبر تاريخ ديمقراطيات تلك البلدان. لا أحد يستطيع اليوم تخيل ديمقراطية دون حق اقتراع عام يمارسه حتى غير الديمقراطيين ودون حقوق ليبرالية وحريات تستفيد منها حتى قوى غير ليبرالية.
ولكن وصول الديمقراطية الينا جاهزة لا يبرر لدعاة الديمقراطية التعامل معها كأنها “فاست فود” أو تقليعة، كما لا يصح الاعتقاد أنه لا توجد لدينا تجرية نبني عليها، فلا الليبرالية العربية بين الحربين العالميتين كلها أخطاء وارتباط بالاستعمار، ولا القومية الراديكالية في الخمسينات والستينات كلها أخطاء. فقد احتوت بعض عناصر الديمقراطية في ظل أنظمة غير ديمقراطية ومنها اشراك الجماهير في السياسة وتعميم التعليم، وتعميم توقع المساواة والعدالة الاجتماعية. وقد قادت الأخير في ظل عدم تلبيته إلى حركات غير ديمقراطية في كثير من الحالات التي تحول فيها المجتمع الجماهيري الى ترييف مدينة لم تستوعبه. ولكن الحركات الديمقراطية الحالية تستطيع ان تستند ايضا الى هذه القيم المتأصلة جماهيريا بفعل تأثير تيارات الخمسينات والستينات. فهذه تقاليد وتجارب راكمها مناضلون كانت لديهم نية حسنة على الاقل، وآمنوا فعلا بالمساواة والحرية وإشراك الجماهير ولكنهم انتهوا الى بناء أنظمة غير ديمقراطية.
ولا شك أن عملية اعادة انتاج الديمقراطية في البلدان المتطورة وتعميمها من النخبة الى عامة الناس واختلاطها بالإعلام والثقافة الجماهيرية وثورة الاتصالات قد انتجت ظواهر من التعفن السياسي تلتها مظاهر التعب من السياسة والعزوف عنها وبحث الشباب عن معنى لحياتهم خارج اطار الحيز السياسي. كما ارتبطت صورة العمل السياسي بالتآمر الحزبي والوظائف والانتهازية النفعية وتغير السياسات والمبادئ قبل الانتخابات وبعدها وقبل ولوج الائتلافات وبعدها، وتحويل الانتخابات الى كرنفال والبرلمان الى سيرك، والمشهدية وحب الظهور والمكاوعة، (التسابق على الكاميرا وعلى الصف الأول بالدفع بالاكواع) والتنافس دون قواعد أخلاقية ضابطة، واستئصال العمود الفقري الأخلاقي من شخصية السياسي بعملية جراحية تجرى عشية ولوج عالم السياسة، والفصل بين الأخلاق والسياسة، وبين الأخلاق الخاصة والعامة...الخ.
ويعرف هذه الظواهر ويعاني منها كل من عمل في السياسة البرلمانية وحافظ على حد أدنى من الحساسية، كما يعرفها كل من راقب العلاقة البورنوغرافية القائمة بين الإعلام التجاري والسياسة والتواطؤ بينهما.. وكلها ظواهر من الديمقراطية المتأخرة القادرة على الاستمرار دون ديمقراطيين لأنها ترسخت كتقاليد ومؤسسات تستوعب غير الديمقراطيين من صغار السياسيين وممتهني السياسة، وبإمكانها تحمل المطابقة بين الواقعي والانتهازي، ومرادفة النفعية بالانتفاع، وبوسعها تحمل اعتبار ال”ريال بوليتيك” نوعا من قابلية السياسي أن يسير على جثث ( مادية أو معنوية) نحو هدفه دون أن يرمش له جفن، واعتبارها موهبة وربما حتى فضيلة وميزة، كما أن بامكانها تحمل اعتبار اخضاع اي قضية مهما كان شأنها لحب الظهور موهبة إعلامية.
لم تكن هذه أخلاق ولا مرحلة ولا نفسية الديمقراطيين المؤسسين أمثال توماس جفرسون أو بنجامين فرانكلين أو دانتون او مازيني او لويس بلانك او قادة الشارتيين وغيرهم من الديمقراطيين الراديكاليين الذين شقوا طريق الديمقراطيات الحديثة كحكم الأغلبية ولو كانت غير ليبرالية، ولا كانت هذه أخلاق الليبراليين الاوائل الذين لم يهتموا بحكم الأغلبية بقدر ما اهتموا بالدفاع عن قيم الحرية والملكية الخاصة، ولو في إطار حكم الأقلية. نقول ذلك دون تقديس لهم فقد كانوا بشرا يؤمنون بقيم تبدو لنا اليوم رجعية ومحافظة، كما أن بعضهم كان يناقض مبادئه في حياته الشخصية، وتكشف الأبحاث عن تناقضات هائلة في سلوكهم. ولكنهم كانوا جميعا أصحاب رؤية راديكالية لا تشتق قيمها من موازين القوى المحلية ولا العالمية، ولا تتبنى الديمقراطية كشعار دولي لان المصلحة باتت تقتضي ذلك. نحن نتحدث عن اناس رأوا في إصلاح النظام السياسي جزءاً من تصورهم للعدل والإنصاف في المجتمع. وكانوا سيبدون غير واقعيين، بل رومانسيين في ايامنا التي يتخذ فيها الديمقراطي شكل “اليابيز”.
وبهذا المعنى نحن نتحدث عن ثوريين في بنيتهم الأخلاقية، وليس عن سياسيين من النوع الذي ينتقل الى الموقف الديمقراطي لانه يرى في ذلك مصلحة آنية دون أن يؤمن للحظة بالموقف الديمقراطي في إطار نضال من اجل مجتمع اكثر إنصافا وأكثر عقلانية، ودون أن يؤمن بالمساواة بين المواطنين كقيمة.
قد تنتهي الديمقراطيات الى ان تصبح الديمقراطية كفكرة مسألة مؤسسات قائمة وراسخة تتم إعادة انتاجها، ونخبة ديمقراطية فعلا تحافظ عليها من طوفان الثقافة الجماهيرية غير الديمقراطية، وقد تتحمل الديمقراطية في مراحلها المتأخرة مواقف غير ديمقراطية عند السياسيين الا بالمعنى الانتهازي وذلك ضمن مؤسسات راسخة وبوجود نخبة ديمقراطية في السياسة والجامعات وفي غابة إعلامية لا تمت لقيم الديمقراطية بصلة. ولكني لا اعتقد انه يمكن البدء ببناء ديمقراطية بهذه النفسيات التي انتهت اليها الديمقراطية المتأخرة، فما كان بإمكان سياسيي اليوم الانتهازيين في الغرب من أمثال بوش الى أصغر مهني حزبي وكاتب خطابات بناء أي ديمقراطية.
وبهذا المعنى فإن نموذج هوجو شافيز وحسن نصرالله ولولا في البرازيل هذه الايام يعد مثلا اقرب في بنيته الأخلاقية، وليس في افكاره او أهدافه، الى ثورية الديمقراطيين المؤسسين من سياسيين يناط بهم أمريكيا أو يريد أن تناط بهم مسألة بناء الديمقراطية في الشرق الاوسط الكبير من أمثال إياد علاوي او الجلبي أو غيرهما.
ارى قلة من الديمقراطيين وشحة في النفسيات الإصلاحية في الحركة التي تتكيف حاليا مع الضغط الامريكي للحفاظ على حكم نفس النخب في المنطقة. والمسألة ليست مسألة كاريزما إطلاقا. الكاريزما فعلا غير موجودة، ولكن ليس نقصها هو المثير. فقد رأينا في هذه المنطقة وغيرها من مناطق العالم الثالث كارزميين كثيري الألوان وشديدي الغرابة جذبوا الصحافيين والصحافيات لمقابلات مثيرة ولكنهم لم يبقوا حجرا على حجر في مجتمعاتهم ولا حتى مما بناه الاستعمار فيها من مظاهر عمرانية. لا حاجة لكاريزما الزعماء الغريبي الأطوار. المزعج وجوديا هو غياب الرؤية، وغياب التطلع إلى مجتمع أكثر عدلا، وغياب الحماس للعدل والإنصاف الذي ميز دعاة بناء الديمقراطية حيث لم تكن موجودة. يبدأ عندنا البعض ديمقراطيته بالانحلال الذي يميز سياسيي الصفقات والائتلافات الحزبية التي تميز مراحل متأخرة من الديمقراطية.
لا يعقل ان يتم في مرحلة التأسيس التعامل مع الديمقراطية في مصطلحات جاهزة من خطابات جورج بوش وكتبتها الأصوليين، وأن تستهلك كما يستهلك الهامبورجر او الكوكا كولا، وان يسمى المستهلك المجتهد في جمع الكوبونات والمقارنة بين محل مكدونالدز وآخر وبين “مول” وآخر فتح حديثا ديمقراطيا.
ما وجه الديمقراطية في توجيه النصائح للفلسطينيين للتخلي عن حقوقهم؟ من ينصح بذلك هو ليس نمط السياسيين الذي يؤسس للديمقراطية. يقف الديمقراطي المؤسس عند الحقوق ويتمسك بها، وينتفض ضد الظلم، ويرفض فرض القوة بدل إحقاق الحق، ويرى أصلا تناقضا أخلاقيا بين الحق والقوة، كما رأته هنا ارندت مثلا في أطروحتها عن العنف.
ليس الديمقراطي مجرد سياسي مهني في إطار ديمقراطي يبحث عن مصلحته أو مصلحة حزبه بموجب موازين القوى القائمة، فيؤيد قرار الأغلبية “الإسرائيلية” الديمقراطية مثلا بشأن مستقبل الفلسطينيين، أو يؤيد حق المرأة بالمساواة بما في ذلك حقها في قيادة طائرة تقصف ايضا الفلسطينيين مثل الرجل. هذه ديمقراطية شكلا، ولكنها تقوم على قيم تكريس قمع واحتلال شعب آخر وتكريس القيم العسكرية التي تكرس دونية المرأة. ليس الديمقراطي هو من يعتبر كلام شارون الرافض للانسحاب ولتنفيذ قرارات مجلس الأمن خطوة الى الامام لانه يتضمن فك ارتباط في قطاع غزة في حين ليس لديه كلمة ايجابية يقولها عن دولة درست الوضع في دولة مجاورة في سياقه الدولي الجديد وقررت سحب قواتها بالكامل من هناك رغم أن قواتها موجودة ضمن اتفاق بين دولتين سياديتين. الديمقراطي في مرحلة التأسيس هو فرد يؤمن بالقيم الديمقراطية ولا يعتبرها حصيلة تبدل مصلحة أو مزاج القوي في عالمنا.
يقول الامريكي الذي تحول من راعي بقر الى راعي الديمقراطية في خطابه الأخير يوم 8 مارس/آذار امام جامعة الأمن القومي “فورت ليسلي ماكنير” ان الانتخابات البلدية في السعودية هي مبشر بالديمقراطية وخطوة الى الامام، كما يرى أن الانتخابات الفلسطينية خطوة للتحرر الفلسطيني من “ارث العنف والفساد” الفلسطيني، وليس من الاحتلال “الاسرائيلي”، ويرى ايضا ان انتفاضة اللبنانيين ضد الوجود السوري هي انتفاضة من أجل الديمقراطية تندرج ضمن انجازات الحرب الأمريكية على الإرهاب التي خصص الخطاب لتعدادها. هل لاحظت عزيزي القارئ ان بوش فطن في خطاب الأمس بقدرة قادر أن يدرج في عملية ضد قواعد المارينز في بيروت من العام 1983 وذكرها بنسق واحد مع عملية 11سبتمبر/ايلول بعد ذلك بسبعة عشر عاما وبعمليات التفجير ضد السفارات الامريكية في افريقيا؟ نقطة للتفكير. وكنا قبل سنوات نذكره بلبنان الذي لم يذكره في اي من خطاباته ولا حتى كمثل على احتمالات وآفاق وبراعم الديمقراطية المبشرة في العالم العربي. فجأة تذكر بوش لبنان بين عملية مقاومة ضد المارينز اعتبرها من نوع عمليات القاعدة واحتجاج لبناني مشروع اعتبر من نوع الثورات المخملية. لقد قص بوش في خطابه تناقضات لبنان الحيوية واختلافاته وتنوعه على مقاسه واختزلها الى النموذج الامريكي في الخير والشر.
ولكن أليس على اي ديمقراطي عربي أن يذكره ان مظاهرة بحجم مظاهرة القوى الوطنية اللبنانية في نفس يوم خطابه تتجمع وتتفرق دون فوضى مئات الأمتار من موقع مظاهرة مناقضة وتمر دون عنف ودون تدخل بوليس وفي مرحلة ازمة حكم هي دليل على انه في هذا البلد تتوفر ثقافة ديمقراطية وجدت قبل ان يتشرف هو بذكر لبنان في خطاباته بهذا الشكل التخريبي الذي يؤسس لفتنة؟ انها وظيفة الديمقراطيين العرب ان يذكروه بذلك. عكست تظاهرات المعارضة والقوى الوطنية اللبنانية ثقافة ديمقراطية. ولا اعتقد ان مظاهرات بهذا الحجم، وفي مثل هذا الاستقطاب السياسي والاجتماعي، كانت سوف تمر بسلام ومن دون غاز مسيل للدموع وجرحى وقتلى في “اسرائيل” الديمقراطية.
لم تنبت الثقافة الديمقراطية اللبنانية من بذرة بذرها تدخل أمريكا في العراق، ولا من خطاب بوش، ولا بعد القرار ،1559 بل كانت موجودة يعيبها التوازن الطائفي والسلالات العائلية وضعف المواطنة مفهوما وممارسة، وتدخل المخابرات في الحياة السياسية وغير السياسية بتواطؤ من قبل تنوع الطوائف والزعامات والسلالات غير الديمقراطي، والتعدد غير الديمقراطي القائم، واستسهال البحث عن عملاء بدل حلفاء أحيانا. وقد استفادت المعارضة اللبنانية من تقاليد ديمقراطية قائمة في تظاهراتها، ولم تؤسس لها كما حصل في ربيع براغ أو انتفاضات جورجيا واوكرانيا وغيرها، كما استفاد منها مؤيدو المقاومة والتحالف مع سوريا في لبنان في تظاهرتهم الجبارة. من الطبيعي الا يذكر بوش ذلك لانه ليس ديمقراطيا، رغم أنه قرأ كتاب ناتان (اناتولي) شيرانسكي واصبح أحد مصادره عن الديمقراطية، بل هو يستخدم الديمقراطية كسياسة هيمنة دولة عظمى. ولكن الا يجدر بالديمقراطيين العرب تذكيره بهذه الوقائع والحقائق اللبنانية؟ تفترض هذه الإرادة رغبة الديمقراطيين العرب بالاستناد الى شرعية جماهيرية، كما تفترض رغبة بدمقرطة الثقافة السياسية الشعبية بواسطة تقريب هم الديمقراطية من هموم الجماهير. ولكن النفسيات المنتشرة تستند الى موازين القوى الدولية والأجندة الأمريكية، وتأمل أن تنعكس هذه الأجندة على ساحتها المحلية دون ان يكون لديها مشروع ديمقراطي متعلق بمستقبل البلد، ودون رؤية شاملة تحررية تشمل فيما تشمل التمسك بمبادئ العدل والإنصاف. وخلافا لما يعتقد ديمقراطيونا الجدد لم يكن الديمقراطيون الأوائل برجوازيين يسعون من أجل الربح ولا كانوا سياسيين فاسدين يبحثون عن رافعة جديدة نحو التحكم بمقدرات المجتمع.
تستطيع ايران أن تصرخ انه ليس لديها سلاح نووي ولا تنوي انتاجه ويرد العالم مع امريكا أنها تريد انتاجه، ويستطيع كيم يونج ايل المجنون المنحرف السفاح ان يصرخ ويقسم أغلظ الايمان مؤكدا أن لديه سلاحاً نووياً، وان تجزره استراليا باسم امريكا بأنه كاذب ولا يملك سلاحا نوويا. ويستطيع الرئيس السوري ان يؤكد ان قرار 1559 هو قرار سيئ ومخالف لميثاق الامم المتحدة اذا جاء بدون تهديد للسلام والامن الدوليين كما ان اياً من الأطراف صاحبة الشأن لم يتوجه طالبا مساعدة مجلس الامن، وانه مع ذلك لا يريد تضييع وقت احد في مناقشة مدى انصاف هذا القرار وعدالته، لأنه لا توجد عدالة ولا يوجد قانون دولي فعلا في عالمنا، وأنه سوف ينفذ الشق المتعلق بسوريا منه رغم ذلك كله. ولا ترد أمريكا ولا حتى بمديح للبراجماتية او الواقعية التي ارتاح لها شعبه على الاقل، ناهيك عن تجاوب المجتمع اللبناني مع هذا الأسلوب، بل تؤكد أمريكا انها انصاف حلول ومناورات سورية. ولا تقول حتى انها خطوة ايجابية تنتظر المزيد. مجرد كلام عدائي عدواني. فسوريا مستهدفة “إسرائيليا” وبالتالي أمريكيا. وحتى لو دخلت ديرا فرانسيسكانيا فسوف يلحقها شارون وبوش مطالبا ان تلغي نفسها على كرسي الاعتراف.
ويستطيع شارون، وهو مجرم حرب معروف، ان يقول بالصوت والصورة انه لا يريد، لا يريد، لا يريد تنفيذ قرارات مجلس الامن بشأن احتلال “اسرائيل” لأراض سورية وتستطيع امريكا أن ترد على الرفض بأجمل منه وبأن تصريحه مع ذلك يشكل تقدما الخ. هكذا يبدو الجانب المظلم من عالم مارثا ستيوارت التي تنشغل امريكا بها حاليا، عالم الاستهلاك الإعلامي وعالم جورج بوش ورامسفيلد وكوندوليزا رايس وبقية البلطجيين. حسنا، ولكن صوت الديمقراطي العربي المؤسس هو الذي يجب ان يبرز في مثل هذه الحالة كصوت العدالة، صوت رفض منطق قرار 1559.
يطالب وزير عربي سوريا من تل ابيب بتنفيذ القرار 1559 فورا وبدون تأجيل. من تل ابيب التي ترفض فورا ومن دون تأجيل تنفيذ اي من قرارات مجلس الامن، وتحتل فورا وبدون تأجيل أراضي عربية وتنكل بشعب عربي وتبني جدارا خلافا لقرارات المحكمة الدولية. ولا توحد البلد كما فعل الجيش السوري بل تقسمها، ولا تبني او تحمي عملية بناء بل تهدم ما كان مبنيا في فلسطين حتى قدومها. فأين الصوت العربي الديمقراطي الذي يعترض بقوة على هذا الكلام في هذا الموقع. يفترض الا يترك الديمقراطي معارضة مداهنة “اسرائيل” الشارونية ورفض هذه الانتقائية في تنفيذ أضعف قرارات مجلس الأمن وأقلها شرعية، للاصوليين غير الديمقراطيين. مثلما لا يفترض ان يعتبر الديمقراطي القضايا الوطنية مجرد شعارات اذا اراد ان يبني ديمقراطية وطنية ذات شرعية شعبية.
هنالك عطب بنيوي يجعل الديمقراطية العربية تبدو كأنها مستوردة كنوع من “الفاست فود” لابناء البرجوازية الوسطى واليابيز من كافة الانواع الذين يعتقدون بكل التواضع المطلوب أنهم يعرفون “كيف يدار العالم” و”كيف تسير الامور” أو “كيف الدنيا ماشية” بمنطق ال “سي اي اوCEO “ ولو سألهم شخص متواضع ان يفسروا له سر ادارة العالم لقالوا كلاما لا يقوله ديمقراطي، من نوع الدنيا مصالح ويجب ان يبحث كل حاكم عن مصلحته.
ولكنهم لم يبنوا ولن يبنوا ديمقراطية من اي نوع. استطاعوا سابقا التعايش مع اي ديكتاتورية ترضى عنهم وعن مسار اعمالهم، وترضى عنها أمريكا حاليا ولاحقا يستطيعون التعايش مع ديكور وإكسسوار إصلاحي. ويستطيعون التعايش مع أي ظلم اجتماعي ومع تعددية طائفية وتوازنات طائفية ودون مواطنة حقيقية.
هكذا تم عن قصد تسويق تحرك مهم فعلا في الشارع اللبناني كأنه ثورة مخملية وتحرك آخر أكبر منه ولا يقل عنه مخملية تم تجاهله في خطاب بوش كأنه لم يكن. اين الديمقراطي العربي في هذه الحالة من هذا التقسيم النوعي للأكثرية كأقلية وللأقلية كأكثرية؟
ثم لا يستطيع الديمقراطي العربي ان يصمت بتواطئ على جريمة اعتبار الاكثريات هي الاكثريات الطائفية والأقليات هي الاقليات الطائفية او العرقية او المذهبية بتجاهل تام للمواقف او الأفكار او البرامج المتطرقة لمصلحة ومستقبل المجتمع ككل وبتركيز على هوية السياسي وانتمائه. ومع ذلك يسود الصمت. ويتم الاستئساد والاستقواء بالموقف الامريكي. وتكفي وجهة دعم الامريكان لتحديد هوية القوى الآخذة بالافول تاريخيا، القوى التي تؤمن بالشعارات الرنانة والطنانة التي عافها الناس من جهة، وهوية القوى الصاعدة الشبابية الربيعية المخملية، وهذه طبعا ليست شعارات رنانة ولا طنانة. أما مسألة مدى ديمقراطية أي من المواقف فتتحول الى مسألة جانبية مقابل المشهد الذي انفعلت منه حتى “اسرائيل” التي لا تصدق ان شيئا كهذا ممكن في دولة عربية. وما ان كمل المشهد بجماهير مسالمة ولكن بأعداد أكبر وتنوع طبقي أكبر خلف شعارات مناهضة ل “اسرائيل” وأمريكا حتى تم تجاهله، وأطلقت عليه تسميات أخرى من نوع تظاهرة الموالين لسوريا، تظاهرة حزب الله، لا ربيع ولا مخمل ولا خمائل.
الطريق الى الديمقراطية تمر من هنا، من الدفاع عن هؤلاء المتظاهرين في وجه بوش الذي يصر على اعتبارهم استمرارا للعملية ضد المارينز. الطريق الى الديمقراطية تمر عبر التلاقي المخملي الربيعي مع هموم الناس من مختلف الطبقات، ومن ضمنها الهم الوطني.
لم يكن الشاعر العربي القديم يبالغ أو يخطىء التقدير وهو يعكس قيمة الحرية والكرامة في البيت المشهور:
ماء الحياة بذلة كجهنمٍ وجهنم بالعز أطيب منزلِ
لقد كان الشاعر بذلك يرفض العبودية والخضوع للقهر أياً كان مصدره ووصل به الاعتزاز بكرامته والتمسك بحريته الى درجة يرفض معها الحياة ذاتها والقبول بالنار إن كان يترتب على الحياة إذلال للنفس وإخضاعها لما لا يليق، ولأن حريته فوق كل اعتبار. وما من شك في أن ذلك كان هو شأن الإنسان العربي في قديم الزمان وهو ما منحه القدرة على مقاومة الأعداء والغزاة ومكنه من الانتصار على كل ما من شأنه أن يضعه تحت ظروف من المذلة والهوان.
وأزعم أن العربي رغم قسوة الأيام واشتداد المواجهات وتنوع الأعداء لا يزال هو ذلك الذي صوره الشاعر القديم إنساناً للتحدي ورفض الاستسلام والخنوع، ومقاومة كل الاغراءات التي تفقده حريته وتقيد آراءه حتى لو كان ذلك التقييد بسلاسل من ذهب. وفي هذا الصدد فإن العربي الذي يؤمن بالحرية ويشتاق الى الديمقراطية وينتظر يوم تحققها بكل طاقات الحنين التي تكونت عبر القرون الأخيرة، لن يقبل تحت كل الظروف أن يبيع حريته وكرامته بأوهام وأحلام من صنع الآخر المراوغ والتي لا ولن يتحقق منها سوى السراب. وهذا هو سبب عزوف العربي التام وتقززه الشامل من ديمقراطية يحملها الغزاة على الدبابات وفي رؤوس الصواريخ!
إن صوت ذلك الشاعر القديم الذي يفضل الموت على الحياة الذليلة لم يكن سوى صوت الحرية والتمسك بقيم الكرامة، وما أظن أن العربي المعاصر على استعداد لأن يتخلى ولو ليوم واحد عن تلك القيم أو يفرط بكرامته مقابل إغراءات يكذبها الواقع وتصطدم أقوالها مع أفعالها. كما أن هذا العربي الذي ترسخت في وجدانه معاني الحرية في أسمى معانيها لن يستجيب لدعاة العبودية الجدد أولئك الذين لا يترددون عن بيع أنفسهم وأوطانهم وتاريخهم لتحقيق مصلحة ذاتية آنية والاندفاع وراء شعارات يطرحها العدو ويراهن على تحقيقها خدمة لمصالحه هو وتمكيناً لأهدافه المتمثلة في السيطرة والهيمنة السياسية والاقتصادية. العربي لن يحتاج للبقاء في جهنم حفاظاً على كرامته، بل يحتاج فقط الى مقاومة الأجنبي الذي يسعى الى استعباده تحت مسميات ودعاوى تثير السخرية والاحتقار.
أكبر أخطاء أميركا في تطور (أو تحلّل) ما أسمته مبادرة إصلاح الشرق الأوسط ليس أنها حاولت ركوب موجة التوق الديمقراطي لدى الشعوب العربية, فذلك كان سيرسيها على شاطئ صلب, بل إنها فقدت بوصلتها الإستراتيجية تماماً إلى حد أن ما تظن أنه شطارة ومهارة لعب على الحبلين أدى إلى أن تدخل حلقة ردود الفعل لأفعال لا تفهم كنهها لأنها لا تفهم فاعليها.
جذور هذا الخطأ الأميركي الإستراتيجي بدأت قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاماً مع هنري كيسنجر ونظريته القائلة إن أميركا لا تحتاج لسياسة خارجية, ولا لدبلوماسية, فقط "لإدارة أزمات" !! وبالفعل لم يعد لأميركا منذ ذلك الحين سياسة خارجية.
وإذا كان ما روج لنظرية كيسنجر لدى الأميركان (فيما يتعلق بالعالم العربي موضوع مقالتنا هذه) هو ما بدا وكأنه إنجاز حققه كيسنجر في اختراق مصر لصالح إسرائيل, فإن هذا, يعتبر أولاً: خدمة سياسية لإسرائيل وليس لأميركا التي فقدت كامل الشارع العربي (أو ما كان تبقى لديها منه).
وثانياً: ما اخترقه كيسنجر كان حالة فراغ سياسي في مصر بعد رحيل زعيمها التاريخي عبد الناصر فجأة. والفراغ لم ينشأ فقط لأن أنور السادات أودع في السجن, حرفيا ومجازياً, كل التيارات السياسية وكل قيادات الرأي بدءاً بالسياسيين وانتهاء بالشعراء والفنانين, بل لأن السادات نفسه لم يشكل بديلاً سياسياً لكل هذا الذي صادره ولا لأي جزء منه, وإنما مثل حالة "خواء" سياسي.
والطريف أن كيسنجر نفسه يعرف هذا عن السادات وهو ما استثمره ليستدرجه إلى طريق لا عودة له بعدها إلى مصر والأمة العربية. حينها توقعنا مصير السادات المحتوم, دون أن نزعم أننا نقرأ الأبراج أو يُكشف لنا الغيب, كما فعل المتنبئون باغتيالات مشابهة هذا العام.
ومعنى يقيننا هذا الذي لم يخطئ, هو أن الذين قتلوا السادات ليسوا الإسلاميين المتطرفين, كل ما حصل أن هؤلاء سبقوا غيرهم إلى هذا. فتصفية السادات كانت الخطوة التالية المحتومة, سواء أدرك ذلك أم لم يدركه كيسنجر, صاحب نظرية "الخطوة خطوة"!!
وقد يكون اغتيال السادات أول "فعل" شعبي عربي في اتجاه التغيير, والأرجح أنه لم يفهم على أنه كذلك من قبل الساسة الأميركان, وفي مقدمتهم كيسنجر مهندس كامل المرحلة حتى احتلال العراق, بل تم إدراجه في قائمة التعميمات الساذجة المسماة "التطرف والإرهاب", ذات القائمة التي أدرج فيها بن لادن والزرقاوي, وانتهى بهما الأمر كأعداء أنداد "للقوة العظمى" و"للقطب الأوحد" في عقر داره وفي قلب مصالحه!!!
كل هذا لأن أميركا لا تقرأ الفعل في سياقه, في إطار فهم الفاعل وفهم التاريخ. وقرار أميركا بأن تتوقف عن القراءة جاء يوم تبنيها نظرية كيسنجر بأن أميركا ليست بحاجة لسياسة خارجية.
ولكي نفهم لماذا يعتقد كيسنجر أن هذا ينطبق على عالمنا العربي (هو أول من أسماه شرق أوسط, ومنه تبلور مشروع بيريز بشأنه وجاءت مبادرة بوش لإصلاحه), علينا أن نتذكر أن كيسنجر يعتقد أن السياسة في العالم العربي هي سوق كل شيء فيه قابل للبيع, وبأن هنالك بائعا واحدا هو "شيخ القبيلة" الذي إن تمنع فلأجل المساومة, وهو يبيع في النهاية!!
وهكذا باع أنور السادات, ولكنه دفع الثمن ولم يقبضه. فالسادات, مثل أميركا التي سار في ركابها خطوة خطوة, أصر على ألا يفهم مدلول الفعل الذي لا يتأتى إلا من فهم الفاعلين وفهم التاريخ, فكانت كلماته الأخيرة: مش معقول!!
وعودة إلى شرق أوسط كيسنجر وبيريز (في تصور أميركا), أو العالم العربي (في رؤيتنا نحن), وما قيل في الإعلام الرسمي من أن الأنظمة العربية رفضت مبادرة بوش لإصلاحه, بينما قال الإعلام الشعبي إن الأنظمة خضعت للضغوط المتضمنة فيها.
وكلا الأمرين صحيح, فغالبية الأنظمة لا تريد الديمقراطية والشفافية والإصلاح لأنها تعتقد أن هذا في غير مصلحتها, وغالبيتها, إن لم نقل كلها, تخضع لأميركا بتفاوت يتناسب عكسياً مع شرعيتها أو قبولها شعبياً داخل أقطارها. والضغط على الأنظمة جزء من أهداف المبادرة!!
ولكي تخرج الأنظمة العربية من مأزق المبادرة مع ضمان إبقاء شيء من ماء الوجه لأميركا عند الشعوب العربية, تم الاتفاق على أن يعلن الطرفان وجوب (حسب النص العربي) وأفضلية (حسب النص الأميركي) أن تكون مبادرة الإصلاح نابعة من الداخل وليست مفروضة من الخارج.
ولا يهمنا هنا ما جرى من تعيين لنساء رجال الحكم في مواقع بالحكم, ولا ما عقد من مؤتمرات تحت رعاية رجال الحكم ونسائهم.. ما يعنينا هو هذا التغيير الذي أُدخل على تعريف الإصلاح السياسي والذي استبدل كلمة "الديمقراطية" بعبارة "الحكم الرشيد" أو "الحكم الصالح"!! وهذا إن بدا وكأنه مقتل طموحات الشعوب العربية للديمقراطية, مرحلياً, فإنه في الحقيقة مقتل مصالح أميركا في المنطقة "إستراتيجياً " وعلى المدى البعيد!!
والسبب أن أميركا لا تفهم الفاعلين ولا تقرأ التاريخ. "فللحكم الصالح" في التاريخ مفهوم بات غائبا عن أدبيات السياسة في الغرب منذ قرون, فهذا التعبير بات جزءاً من تاريخها القديم السابق لكل أشكال الديمقراطية الغربية منذ بواكير نشوئها وحتى تبلورها في أشكالها الحالية.
بل إن تعبير "الحكم الصالح" لا نجده عندهم إلا في أدب الأطفال, في حكايا الملك الصالح والملكة الشريرة ومرآتها الناطقة والأميرة المسحورة النائمة بانتظار الأمير المخلّص.. وينتهي الأطفال إلى اكتشاف أنه مجرد خيال لاعلاقة له لا بالواقع ولا بالتاريخ, ويأسفون على الكذبة الحلوة التي لم يعد بالإمكان تصديقها, تماما كما يأسفون على سانتا كلوز!!
أما في التاريخ العربي, فإن الماضي متصل بالحاضر على امتداد أكثر من أربعة عشر قرناً. فمن الخليفة العادل عمر الفاروق, إلى عمر بن عبد العزيز(الذي يقرن بابن الخطاب رغم الفروق الجذرية!!) إلى المعتصم (الذي لبى نداء امرأة واحدة على حدود بلاده وسيّر لها الجيوش وقهر جحافل الروم!!) إلى هارون الرشيد (الذي بدت أوروبا بدائية في ظل الحضارة التي أوصل إليها إمبراطوريته العربية) إلى صلاح الدين (محرر بلاد العرب من الغزاة التتار) إلى محمد علي (صاحب رسالة التنوير وأبي النهضة العربية) إلى عبد الناصر(رمز الوحدة العربية ونظافة اليد في الحكم) إلى صدام حسين (مجسد حلم أن نفط العرب للعرب ووريث صلاح الدين عسكرياً في نظر الشعوب حتى اقترن الاسمان).. والأخير شارف حد الأسطورة وهو حي وفي أواخر القرن العشرين وليس في خرافات موروثة من قرون مضت.
فقد عمت العالم العربي روايات عن ظهور اسمه مضيئاً في السماء, حين كانت جيوش التحالف الثلاثيني تحشد ضده. أما من كانت لهم تحفظات عليه من الكتاب السياسيين, فقد عاد و"تطهر" في نظرهم, بل وباتت سيرة عائلته تقرن بمأساة الحسن والحسين, حين قتل ولداه في قتال غير متكافئ لم يستسلما فيه وآثرا "الشهادة".
وصدام نفسه أصبح "شيخ الأسرى" العرب عند المحتلين لأرض العرب في العراق وفلسطين, واستحضر معارضوه السابقين قصائد رثاء قيلت في عبد الناصر عند وفاته من قبل شعراء كانوا معتقلين في سجونه أثناء حياته, وفي مقدمتها قصيدة الشاعر الشعبي أحمد فؤاد نجم التي يقول فيها "إن كان جرح قلبنا, كل الجراح طابت" (أي شفيت)!!
هذا التراث يتشارك فيه التياران الأقوى على الساحة العربية: القوميون والإسلاميون، وهما لا يختلفان فيه إلا حديثاً جداً, على عبد الناصر وصدام بالذات. والسبب ليس لأن لهذين الزعيمين خلافات وصدامات مع الإسلام السياسي, فلهما صدامات مع غيره وأحدثوا جراحاً كلها "طابت".
الصدام هو لأن الإسلاميين بالذات ليسوا معارضة "ديمقراطية" كما يحتم الحكم الشمولي لهذين أن تكون المعارضة (فالنهج القومي لا يجرؤ أحد على الجهر بالاعتراض عليه), وإنما هم معارضة "إحلالية".. يريدون الحلول محل هذين ومحل كل الحكام العرب, ويزعمون أنهم المؤهلون أكثر ليكونوا "الحكام الصالحين" أي "الديكتاتوريات العادلة"!! وتبقى المعارضة العربية الحقيقية هي تلك الفئة المتنورة التي تأثرت بالحضارة الغربية في مكونيها الرئيسيين: العلم (العقلانية) والديمقراطية, وعلى يدها بدأت النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وتوارثتها عبر أجيال مثقفيها.
هذه الأقلية تمكنت في العقود القليلة الماضية من حشد أغلبية كبيرة في الشارع العربي, تضم الليبراليين والقوميين واليساريين وحتى رجل الشارع البسيط, وراء مطلب واحد مشترك هو الديمقراطية.
هؤلاء عمر دعوتهم الحداثية قرن واحد, ولكنهم قووا وانتشروا بفعل إقناع العقل وقوة المنطق, وليس بهالة قداسة أو سحر أسطورة تجيّش "مجاهدين" إسلاميين أو "فدائيين" قوميين.
الآن حين يخذل العالم الديمقراطي هؤلاء, ويقال لكل من ساروا وراءهم إن الديمقراطية عندما تترجم للعربية تصبح "الحكم الصالح لحكام فاسدين".. فإنهم لا يملكون إلا سحب دعوتهم الفتية, وانتظار "خليفة" مهدي منتظر, أو زعيم قومي مخلّص, يضيء اسمه سماء ليل الأمة المظلم!!
حلم الشعوب العربية هذا, هو أكبر من مجرد "أزمة" بالنسبة لأميركا, هو أسوأ كوابيسها على الإطلاق.. وعندما يتحقق ستكتشف أميركا أن النهج الكيسنجري في "إدارة الأزمات" قد ورطها, خطوة خطوة, فيما هو أكبر من حرب فيتنام التي استنزفتها لأربع سنوات دامية.. ستكتشف أنها على امتداد خمسة وثلاثين عاماً قد استنزفت بنفسها كل ما يلزمها للعب دور ذي شأن في "السياسة الخارجية" حين أضاعت بوصلتها!!









 لتحميل جريدة الخبر : :......
لتحميل جريدة الخبر : :......
 لتحميل جريدة النهار الجزائرية :......
لتحميل جريدة النهار الجزائرية :......  لتحميل جريدة الفجر الجزائرية :......
لتحميل جريدة الفجر الجزائرية :...... 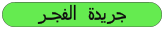 لتحميل جريدة صوت الأحرار :.....
لتحميل جريدة صوت الأحرار :.....